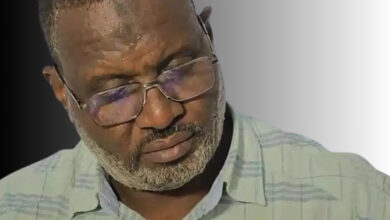عثمان ميرغني يكتب.. قصتي مع الأستاذ طاهر

حديث المدينة الأربعاء 6 أغسطس 2025
قصتي مع الأستاذ طاهر
في سنتي الأولى بالمدرسة المتوسطة في مدينة حلفا الجديدة، نجحت في الامتحان وحققت المركز الأول في الفصل. كان ذلك إنجازًا يستحق التصفيق الحار عند إعلان النتيجة.
في العام التالي، اشتدت المنافسة. كانت الأحصنة المتسابقة تقترب من عرشي مع كل ورقة امتحان تُعلن درجاتها. وجاءت الورقة الأخيرة، مادة اللغة العربية. ما زلت متقدمًا، لكن الفارق بيني وبين منافسي كان ضئيلًا. كنت في حاجة ماسة للمحافظة على كل درجة، فقد كانت تعني إما بقائي على القمة أو فقدان “شرعيتي”.
عند توزيع أوراق الإجابة، وجدت أنني خسرت درجتين ونصف درجة، تفصلني عن الدرجة الكاملة. خسارة كبيرة في ظل المنافسة الحادة وضيق الفارق. طلب منا أستاذ اللغة العربية مراجعة أوراقنا، مؤكدًا أنه لن يقبل أي مراجعة بعد انتهاء الحصة. في خضم التوتر، لم أنتبه في البداية إلى خطأ في حساب الدرجات، لكن في اللحظة الأخيرة، قبل أن يغادر الأستاذ الفصل، اكتشفتها: كنت مستحقًا للدرجة الكاملة!
رفعت يدي ونبهت الأستاذ، لكنه، وهو يغادر الفصل بسرعة، رد بحسم: “انتهى الوقت، ولن أغير الدرجات!” وواصل طريقه منهيًا الحصة. في صغري، لم أكن قادرًا على التفكير طويلًا. كان لا بد من طريقة لـ”استئناف” قرار الأستاذ.
حملت ورقة الامتحان واتجهت إلى مكتب مدير المدرسة، “الناظر”، ذلك الشخص الذي نهابه ونتجنب لقاءه حتى بالصدفة. لا أحد يجرؤ على مواجهته مهما كانت الأسباب. لكن لم يكن أمامي خيار. وقفت عند باب مكتبه، وطرقت الباب بما تبقى لي من شجاعة، وعيناي تكادان تذرفان الدموع.
“ادخل!” ناداني. وكأنني أحمل صخرة ثقيلة أتوق للتخلص منها، مددت له ورقة الامتحان وقدمت شكواي: “الأستاذ رفض أن يحسب لي درجتين ونصف درجة!” أدرك اضطرابي، فابتسم ليطمئنني، ثم راجع الورقة وقال: “معك حق”. كتب مذكرة للأستاذ ينبهه إلى الخطأ ويطلب تصحيح الدرجة.
طرت فرحًا وقطعت المسافة بين مكتب الناظر وغرفة المعلمين بسرعة الضوء. وجدت الأستاذ محاطًا بمجموعة من الطلاب، فمددت له الورقة مع مذكرة الناظر وتوقيعه. فجأة، ثار وهاج بطريقة لم أتوقعها، وقال في غضب: “تشتكيني للناظر؟!” لم يمهلني لأوضح أنها ليست شكوى، بل استئناف لحقي. صحح الدرجة، ثم ألقى الورقة في وجهي أمام زملائي.
عدت إلى الفصل وجلست في مقعدي، أبكي من الإهانة. لكن زميلي بجواري خفف عني وهو يواسيني: “لماذا تبكي؟ أنت الأول!”
كانت “شرعيتي” في زعامة الفصل على المحك. لو كنت ابن أحد النافذين، لما احتجت إلى السهر والتعب والجري وراء كل درجة للحفاظ على مركزي. لكن الشرعية هنا تأتي بالإنجاز والدرجات فقط. أذاكر وأجتهد وأتعب، أجري وراء كل درجة، حتى نصف درجة، لأحافظ على عرشي.
مديرك في العمل، وزيرك، رئيس حزبك، رئيس بلدك.. هل يمكن أن يفقدوا شرعيتهم لأي سبب ؟ لم التعب والسهر والاجتهاد، طالما أن الشرعية مضمونة ولا علاقة لها بالإنجاز؟
البشير ظل رئيسًا للسودان 30 عامًا، لا ينازعه في “شرعيته” شيء. الانتخابات كانت “مضمونة”. فلماذا يتعب من أجل الشعب إذا كانت شرعيته غير قابلة للنقاش؟ لولا ثورة 11 أبريل 2019، لكان لا يزال رئيسًا حتى اليوم، “ينام ملء جفونه عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصم”.
ثم جاء حمدوك، ومن أول يوم شكرا حمدوك.. الدرجة الكاملة قبل أن يدخل قاعة الامتحان، بل و”فوقيها بوسة”. فلماذا يتعب ويسهر إذا كانت شرعيته مضمونة بلا امتحان؟
في تاريخنا السياسي المعاصر، علة السودان هي “الشرعية”. يستوي من يدخل القصر بدبابة، أو بالانتخابات، منذ انتخابات 1953، كانت الديمقراطية صورية، أبدية. أحزاب مثل الأمة، الاتحادي، الشيوعي، المؤتمر الوطني، البعث، ومشتقاتها.. هل يمكن تغيير قيادتها؟ حتى المؤتمر الوطني، بعد سقوطه، هل تغيرت قيادته؟ الشرعية هنا أبدية، فلماذا التعب؟
الحل للإصلاح السياسي يكمن في إعادة هندسة “الشرعية” لتكون دائمًا على المحك. كيف؟ بربطها بالعمل والإنجاز فقط، في كل المستويات. نحتاج إلى امتحان بدرجة قصوى، أسئلة محددة، درجات لكل إجابة، وزمن محدد لتسليم الورقة. لا يهم من يحكمنا بعد ذلك، سواء رئيس السيادة، رئيس الوزراء، الوالي، أو رئيس لجنة الحي. الجميع يخضع لامتحان بأسئلة ودرجات وزمن محدد. عند الامتحان، يكرم المرء أو يهان.
السيد رئيس مجلس السيادة البرهان، الدرجة القصوى 100، لكل سؤال درجة، وعقارب الساعة تدق بسرعة كمباراة كرة قدم. إذا انتهى الزمن، نجمع الأوراق، والحساب واضح: نجاح بامتياز، نجاح عادي، أو رسوب، بلا إعادة.
رئيس الوزراء ، استلم ورقة الامتحان، الأسئلة واضحة، الدرجات محددة، والزمن معلوم.
ولاة الولايات، مدراء الوحدات والشركات، إلى أدنى مستوى سلطة..
كلنا محكومون بورقة امتحان، كراسة إجابة، وزمن محدد. إما نجاح، أو سقوط، بلا إعادة ولا ملاحق
نقلا عن – صحيفة التيار